في إحدى مقابلاته، عبّر فيديريكو فيليني عن رغبته في الابتعاد عن السرد التقليدي في السنيما قائلا: أحاول تحرير عملي من بعض القيود. فقصة ذات بداية وتطور ونهاية يجب أن تكون أشبه بقصيدة ذات وزن وإيقاع!
ولو قدر لفليني أن يختصر رؤيته في ثلاث جمل لربما قال: لا تنتهي أفلامي أبدا. وليس لها حل بسيط. ومن غير الأخلاقي أن تروي قصة لها خاتمة!

كأن فليني كان يرفض أن تختزل الحياة في ثلاثة فصول مرتبة بعناية. يرى أن القصص، حين تُغلق نهاياتها، تفقد صدقها. فالعالم لا يمشي على إيقاع الحكايات بل على نبض القصائد: فوضوي، موجوع، متردد، لا يُروى بل يُحس. وفي La Dolce Vita لا يعود مارشيلو من تيهه بخلاص أو توبة، بل بشاطئ صامت، وفتاة تناديه من الضفة الأخرى. لا يسمعها، أو لعله لا يريد. كل شيء في المشهد يوحي بنهاية لكنها تترك معلقة، كنداء لا يجاب. وهكذا لم تكن أفلامه تبحث عن حل بل عن أثر. كانت تترك باب الجحيم مواربا. لا ختام. لا خلاص. لا مهرب من الذات.

بمعنى آخر: لا أحد ينجو من نفسه. لا في السينما، ولا في الحياة، ولا في أرشيف الإنترنت. وبالنسبة لي، فقد كنت لأظن، لو سمعت مثل هذا الكلام لأول مرة وسواء من فليني أو غيره، أنه ينتمي إلى تلك التنميقات الكلامية أو الفلسفات الشاعرية التي بالكاد تصلح لخطاب في مهرجان كان، لولا أنني وجدتُ نفسي أقلب في مقالاتي القديمة وأدركتُ أنني، بلا وعي، كنت أعيش هذا الجحيم المستمر، حيث لا حل بسيط ولا ختام يليق بالتوق الأخلاقي والوجودي المحموم. وحيث لا شيء يُمحى، ولا فكرة تموت، وكل ما كتبته يوما ما قد يصبح شبحا يلوح لي من أحد ال Zombie Websites المهجورة، حيث لا تزال حروفي تتسكع هناك مثل شخص طُرد من الزمن لكنه نسي الرحيل.
الكلمات نفسها تنفجر سخرية من عذابات كاتبٍ يكاد يغرق على شواطئ الكلمات وعلى الضجيج الخافت لهذه الملحمة السريالية التي تدور حول رجل يطارد ظله

جريمة قتل مع سبق الإصرار.. لكن الضحية تعود كل مرة؟
في عام 1967، أعلن رولان بارت موت المؤلف، لكنني أؤكد لكم أن المؤلف لا يموت، بل يتحول إلى مخلوق رقمي غريب يعيش في ذاكرة التخزين المؤقت لجوجل. كل مقالة كتبتها قبل عشر سنوات لا تزال هناك، تتنفس، تتكاثر، ترفض أن تُدفن، مثل قصص Westworld التي يظن أبطالها أنهم أحرار، بينما قصصهم وأنفسهم مجرد نسخ متكررة تسير في حلقة عبثية.
وإذا كنتَ ممن يجوبون الإنترنت بحثاً عن شيء ما، فقد تكون مررت عن طريق الخطأ أو الصواب بمقالاتي القديمة، التي كتبتُها كما يكتب إميل سيوران عن الانتحار وهو يحتسي الإسبريسو، ثم هجرتها كما هجر غوستاف فلوبير أوهامه عن الحب المثالي، ثم عدتُ لأجدها هناك، تحدّق فيّ كما يحدّق ميشيل فوكو في فكرة “الجنون”، متسائلا: “هل أنت متأكد أنك كنت طبيعيا عندما كتبت هذا؟”

أنا.. لكن بنسخة أقدم
حين أعود لقراءة مقالاتي القديمة، أشعر كأنني أعيش في الموسم الثاني من Westworld، حيث لم تعد النسخ الاصطناعية مجرد مضيفين، بل أصبحت تُخلق للزوار أنفسهم، بناءً على بياناتهم وسلوكهم.
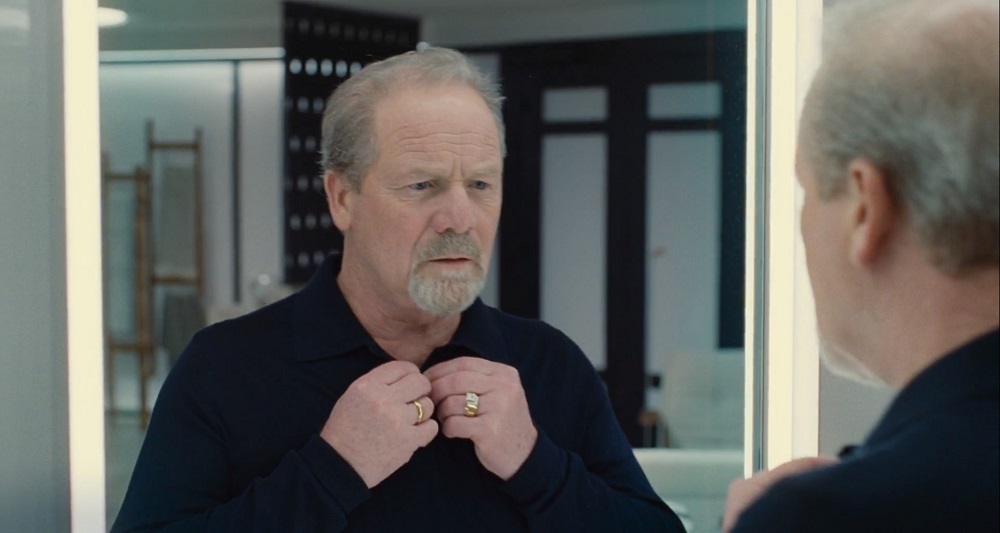
تماما كما كان جيمس ديلوس، رجل الأعمال الذي حاول تكرار نفسه في جسدٍ اصطناعي لكنه فشل مرارا، أجد أنني أعود إلى نفسي القديمة وأحاول أن أفهمها. أراقب كيف كانت تتحرك، كيف تفكر، كيف تبرر نفسها، لكن دون أن أشعر أنها أنا تماما. نسخة مني، لكنها نسخة غير مستقرة، تعيد نفس الأخطاء، تكرر نفس العبارات، تكتب بحماسة مخيفة ثم تنهار تحت ثقل الزمن.
في كل مرة أقرأ فيها مقالا قديما لي، أكتشف أنني كنت أحاول إعادة خلق نفسي في كل مرحلة. لكن، وكما اكتشف ديلوس في محاولاته المتكررة، لا يمكن لأي نسخة أن تتطابق تماما مع النسخة الأصلية. فنحن محكومون بالتغير، محكومون بأن نصبح شيئا آخر باستمرار.
الكاتب كدمية في يد غرائزه (وهو مقتنع أنه يكتب بوعي شديد)
لطالما تغنيتُ بحرية الفكر، وبأن الكتابة “مشروعٌ عقلاني”، لكنني كنتُ أكتب بدافع غرائزي خالص، كما يكتب كلبٌ عن فلسفة أكل العظام، أو كما كان يكتب ماركيز دي ساد عن حرية الجسد في زنزانته الباريسية، مقتنعا أن العالم يحتاج إلى المزيد من نظرياته عن الانحراف.

كنتُ أكتب بانفعال، بدم ساخن، كأنني محاربٌ قديم يرسل رسائل أخيرة إلى حبيبته قبل أن يلقى حتفه في معركة خاسرة، ثم بعد عام، أعود لقراءة ما كتبته، فأجد أنني كنت أقاتل في الجانب الخطأ، وأن “الحبيبة” لم تكن سوى فكرة رومانسية سخيفة زرعتها في رأسي سينما إنغمار بيرغمان بتجهمها الوجودي، أو قصائد بودلير المتعفنة برائحة العدم.

لكن، لا بأس، من منا لم يمر بهذه المرحلة الساذجة من الحماس المفرط؟ لا تحكموا عليّ بقسوة، فكما يقول المثل: “كان ذنبا ثم أصبح تجربة ثم صار حكمةً ثم تحول إلى محاضرة أخلاقية ألقيها على الآخرين!”
إن لم تستحِ فناقش نفسك
تخيلوا رجلاً يكتب مقالا ناريا عن الاشتراكية العلمية، ثم بعد شهور يكتب مقالا آخر عن فضائل السوق الحرة، ثم بعد سنة ينشر مقالا صوفيا عن الزهد والروحانية، ثم بعد عامين، يهاجم كل ذلك بوصفه “أوهاما برجوازية زائفة”!

ما الفرق في النهاية بين عازف شارد في عرض موسيقي، وبين نزار في فيلم أمريكي طويل، الذي بدأ رحلته كأيقونة الحزبية المتحمسة، لكنه ينتهي متشرذما، تائها، فاقدا لليقين الذي كان يظنه صلبا كالرخام.

نزار ليس مجرد شخصية حزبية، بل هو الكليشيه الحي للمناضل الفتيّ، الذي يحفظ كتيبات ماركس ولينين عن ظهر قلب. يردد الشعارات كما لو أنها تعاويذ تحميه من الشك، لكنه مع كل مشهد جديد، يتضح أنه مجرد خيط في نسيج عبثي أكبر منه. إنه مثال لمنحنى الشخصية المكسور (broken character arc)، الشخصية التي تبدأ متوهجة بانفعالاتها، متماسكة بأفكارها، ثم ينكشف الوهم شيئا فشيئا، حتى يتحول بريقها إلى رماد، تماما كما يحدث عندما تعود إلى كتاباتك القديمة وتدرك أن صراعاتك الفكرية لم تكن أكثر من حلبة سيرك، حيث كنت تؤدي عروضا فكرية أمام جمهور من الأشباح الرقمية التي لا تصفق ولا تعترض، لكنها لا تنسى أيضا.
أما رشيد، فهو كابوس عبثي آخر، لكنه أكثر انفتاحًا على فوضويته. رشيد هو ذلك النوع من الشخصيات التي لا تبحث عن الحقيقة، بل عن الضجيج، عن المعركة بحد ذاتها، بغض النظر عن فحواها. لو وُجد رشيد اليوم، لكان أحد هؤلاء الذين يقضون يومهم في تغريدات مشحونة، ثم في الليل يرفعون منشورا طويلا عن “الهروب من صخب العالم”، قبل أن يعودوا في اليوم التالي إلى حلبة الصراع الرقمي، وكأنهم نسوا لحظة التأمل الوجودية تلك.

رشيد لا يمر بمنحنى شخصية. رشيد هو المنحنى ذاته. إنه كائن يتحرك على الدوام بين الانفجار والانطفاء، بين الوعي واللامعنى، بين التنظير الفلسفي والسقوط في شِباك ذاته المتاهية. لو أن مسرحيات زياد كانت سلسلة تلفزيونية، لرأينا رشيد يظهر في كل موسم بنفس الشخصية لكن بأزياء مختلفة، تارةً كمناضل، تارةً كواعظ، وتارةً كمهرج يرتدي بدلة رسمية ليثبت أنه “جاد هذه المرة”.
لكن المفارقة العجيبة أن هذه الشخصيات، رغم عنفوانها وصخبها، تظل أكثر قابلية للتلاشي مقارنةً بشخصيات جامدة وثابتة ظاهريا، لكنها أكثر اتزانا من الناحية السردية. خذ أبو ليلى في فيلم أمريكي طويل مثلا. إنه كتلة من السكون الظاهري، لا يحاول إثبات شيء، لا يدخل في معارك أيديولوجية، لكنه على الأقل لا يضيع في متاهة أفكاره كما فعل نزار. أو انظر إلى رامز في بالنسبة لبكرا شو، الذي بدا طوال المسرحية كشخص هادئ أو ممل حتى، لكنه في النهاية الشخص الذي يملك مفتاحا ما من مفاتيح اللعبة حتى ان الخواجا ينتبه إلى موهبته، بينما رضا ونجيب ينتهيان وكأنهما مقطوعتان موسيقيتان لم تكتملا، أو بالأحرى، لم تكن لديهما النية للاكتمال من الأساس.

رامز قد يكون مجرد موظف في مكاتب هذا العالم، لكنه ليس نسخة تالفة من نفسه. إنه مثل تنويعات جولدبيرغ لباخ Bach s Goldberg Variations: تكرار مع اختلاف، لا تحوّل جنوني مثل نزار أو رشيد. أو لعله أقرب إلى موسيقى موزارت التي وصفها البعض بأنها “بسيطة لمن يسمعها، معقدة لمن يحاول عزفها”، فهو يبدو نمطيا، لكنه أكثر تركيبا من كل الفوضى التي تدور حوله.

أما رضا ونجيب، فهما مثل شخصين عالقين في كابوس فيلم من افلام لويس بونويل، يتحدثان، يخططان، يتحركان، لكن لا أحد يعرف إلى أين ولماذا. إنهما مثل الكتابات القديمة التي لا تزال عالقة على الإنترنت، لا تختفي، لكنها أيضا لا تعني شيئا بعد الآن. يمكنك أن تراها، لكنك لا تشعر أنها حقيقية!
وهنا المفارقة الكبرى: كل شخصيات الفوضى في مسرح زياد الرحباني: نزار، رشيد، حتى زكريا،،، كانوا يعتقدون أنهم في قلب الحكاية، بينما الحقيقة أنهم مجرد فصول عابرة في قصة أكبر لم يدركوها. بالضبط كما يحدث عندما نكتب مقالاتنا القديمة، مقتنعين أننا نمسك بالحقيقة المطلقة، ثم بعد سنوات نكتشف أننا لم نكن أكثر من ممثلين في مشهد جانبي في مسرحية كتبها شخص آخر تماما.

الكتابة بوصفها مقبرة مفتوحة
لا يهم كم مرة نحاول قتل أفكارنا القديمة، فهي تبقى هناك، محفوظة في أرشيف الإنترنت مثل الموتى الذين رفضت المقابر ابتلاعهم تماما. ربما لاحظتَ تلك ال Zombie Websites التي وصفتها في البداية: المواقع التي توقفت عن تحديث نفسها منذ سنوات، لكن محتواها ومقالاتها لا تزال هناك، تلوح لك مثل أشباح تائهة في العصر الرقمي.
وهكذا، بينما ننشغل نحن بتوسيع مقابرنا الفعلية لاستيعاب مزيد من الأجساد، يقوم الإنترنت بتوسيع مقابر رقمية للكلمات. الفرق الوحيد؟ أن المقابر العادية تحمل أسماء الراحلين، أما المقابر الرقمية، فهي تُبقيك حيا حتى وأنت تحاول أن تتبرأ من حياتك التي تعيشها، أو على الأقل من نفسك التي تحملها.
وربما لهذا السبب، عندما وقف فريدي ميركوري في واحد من أواخر الظهورات شبه الرسمية له في كليب The Show Must Go On، محاطا بمشاهد مجد قديم ووهج مسرحي آخذ في الانطفاء، كان يعلم أنه على وشك أن يصبح جزءا من الأرشيف، لكنه لم يتوقف عن الأداء. عيناه كانتا تقولان ما لم تقله الكلمات: “لا شيء يموت هنا حقا، لا الإنسان، ولا الكلمات، ولا حتى المسرحيات القديمة التي كنّا نريد نسيانها”.

لذلك، لو صادف ان كنت في ورطة تشبه ورطتي فلا تفعل مثلي. لا تكترث. لا تقلق كثيرا بشأن مقالاتك القديمة، فهي ستبقى هناك، حتى لو أنكرتها، حتى لو حاولت دفنها، حتى لو قررت أنك أصبحت شخصا آخر. لأن العرض يجب أن يستمر، حتى لو لم نعد نحن نفس المؤدين على خشبته.
محمد عبد القادر الفار (قادر) \ مارس 2025
محمد عبد القادر الفار
محمد عبد القادر الفار
محمد عبد القادر الفار

أضف تعليق