ليست كل مقدمة موسيقية مجرد مدخل إلى الأغنية. أحيانا تكون خلقا مستقلا، مسرحا للتمهيد، أو برزخا زمنيا يسبق نزول الكلمة. سأذهب هنا إلى ما هو أبعد من التذوّق الفني، محاولاً تأمل البنية الخفية التي تربط بين الموسيقى والخلق، بين الغناء والكلمة، بين اللحن والكون.

الموال: أنين الخليقة قبل الكلمة
قبل أن يدخل الصوت على اللحن، هناك ما يشبه التنهيدة الكونية: موال طويل، يتلوّى فيه الصوت كأنه يختبر الجراح القديمة للوجود. فالموال لا يقول، بل يتوجّع. لا يخبر، بل يتأمل. إنه البكاء الأول قبل النطق، أو لنقل: هو الروح تتدرّب على التجلي قبل أن تسكن الجسد الغنائي.
ولهذا يكون الموال غالبا مرتجَلا، لأن الألم الحقيقي لا يُكتب بل يُنزَف.
وكأن المغني، حين يموّل، يفتح فمه كالنبيّ، يناجي الغيب في لحظة ضعف مشرّف، قبل أن يعلن رسالته الشعرية.

المقدمة الموسيقية: زمن التجلي
ليست كل الكائنات تولد في اللحظة نفسها. فبعضها يحتاج صرخة، وبعضها يحتاج تسعة أشهر من التكوين في رحم الصمت. وكذلك الأغاني،،
فأغنية من الأغاني الطويلة لعبد الحليم أو أم كلثوم لا يمكن أن تبدأ مباشرة، لأن النص فيها ليس مجرد كلمات، بل وحي ثقيل.
والوحي، حين يكون ثقيلا، يحتاج تمهيدا، ارتجاجا داخليا، كأن الأوركسترا كلها تشارك في فتح باب الغيب، حتى يدخل الصوت متجلّيا. طول المقدمة هنا هو الزمن الذي تتشكل فيه الكلمة قبل أن تُنطق. هو زمن إعداد المستمع ليصبح كائنا قادرا على التلقي.
كأن اللحن يخلقك أولا، ويجعل منك إنسانا جديدا، قبل أن ينفخ فيك الكلمة فتنهض حيا.

وقد تناول الدكتور سعد الله آغا القلعة هذا البُعد في تحليلاته الدقيقة لمقدمات أم كلثوم ضمن برنامجه “نهج الأغاني”، حيث لم يتوقف عند الجانب اللحني فقط، بل كشف كيف تتحوّل المقدمات الطويلة إلى حوار تمهيدي بين الروح والمستمع، كأنها رواية صامتة تُحكى قبل أن يبدأ الكلام.
ولعل توصيف بعض النقاد للمقدمات الموسيقية الطويلة بأنها “لزوم ما لا يلزم” يكشف عن الفجوة بين من يرى الموسيقى كضرورة وجودية، ومن يراها مجرد ديباجة يمكن الاستغناء عنها. لكن، لعلهم لم يدركوا أن ما “لا يلزم” يكون، على الأقل في بعض الأحيان، هو بالضبط ما يُنقذنا من ضيق اللحظة ويمنحنا فسحة التأمل قبل أن تهجم علينا الكلمات.
وهنا، ندرك أن طول المقدمة ليس مجرد ترف موسيقي شرقي، بل هو فن هندسة التهيؤ، حيث تُصاغ اللحظات التي تسبق نزول الكلمة كأنها طقس انتظار للوحي.

لكن العبقرية أحياناً، تُعلن عن نفسها بلا استئذان.
فهناك لحظات لا تحتاج إلى تمهيد، لأن الكلمة نفسها تحمل في نبرتها كل الأوتار الممكنة.
خذ مثلا فريدي ميركوري في أغنيته:
Love Me Like There’s No Tomorrow
لم ينتظر عزفاً طويلاً، لم يستدعِ الأوركسترا لتُفرش له الطريق، بل دخل مباشرة كما يدخل العاشق حين يداهمه الخوف من الفقد: بلا سلام، بلا مقدمات، فقط الحقيقة تُقال، وكأن الوقت عدوٌ لا يُمهل.
وكأن فريدي، بطريقته الساخرة من كل القواعد، يهمس: “إن كان الغد مفقودا، فلن أضيع اليوم في عزف المقدمات.”

وعلى الضفة الأخرى من العالم، حيث الرُقيّ المشرقي وهدوء الجبال، تُفاجئك فيروز في النسخة المسجلة من “سنرجع يوما”، بدخول مباغت بعد ضربة مفتاح واحدة فقط، كأنها تقول بصوتها: “لستُ بحاجة لأن أمهّد للحنين، فهو يسكنك أصلا.”
هذا التكنيك: الدخول اللحظي المباشر، ليس تسرعا، بل هو نوع من العبقرية التي تعرف متى تُلقي بك في البحر دون أن تعلّمك السباحة.
لأنها تثق أن الموجة الأولى كفيلة بأن تُعيد لك ذاكرة الطفو.

وإن لم تُفاجَأ بعد، فاسأل فريدي مرة أخرى، ومعه فرقة Queen هذه المرة عن معنى أن تُسقط المستمع في الهاوية من أول نفس. ففي رائعة Bohemian Rhapsody، لا مقدمة، لا تمهيد، لا عزف ينتشلك بلطف،،
بل تداهمك المجموعة بسؤال كوني وقح:
“?Is this the real life? Is this just fantasy”
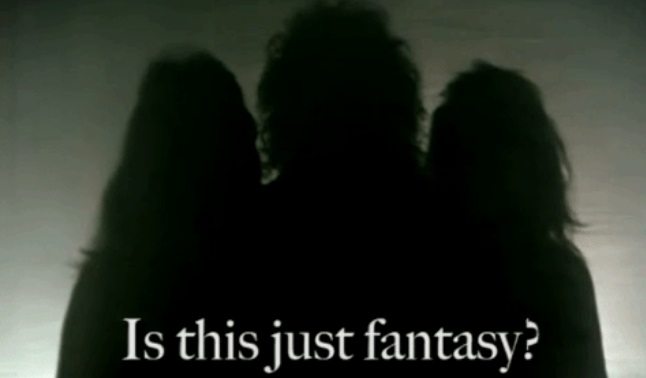
كأن الأغنية لم تأتِ لتغني لك، بل لتُشكك في وجودك ذاته قبل أن تُكمل قهوتك!
إنها لا تمنحك فرصة للتهيؤ، لأنها ببساطة تفترض أن من يعيش في هذا القلق لا يحتاج مقدمة ليسقط.
في تلك اللحظة، تدرك أن بعض العبقريات لا تعبأ بأن تُهندس لك مدخلا، بل تفضّل أن تقتلعك من جذور وعيك، وتتركك معلقا بين “الحقيقة” و”الفانتازيا”.
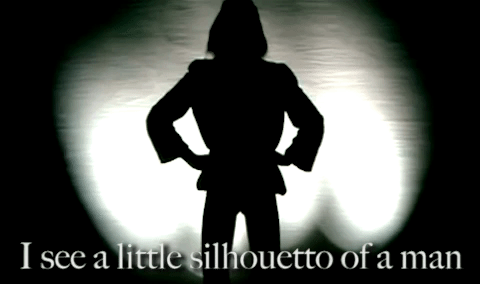
الأوفرتور: سمفونية ما قبل الحكاية
في الأوبرا والمسرح، لا يبدأ العرض بالكلمات، بل بOverture، قطعة موسيقية تمهّد للعاصفة، تستعرض فيها الأوركسترا كل المواضيع العاطفية والفكرية التي ستظهر لاحقا في العمل، لكن بلا تفسير، بلا شرح.، فقط موسيقى.
كأن المؤلف يقول: “سأخبرك الآن بكل شيء، لكن بلغة لا يفهمها إلا من يستعد.”
الأوفرتور، رمزيا، هو زمن البرزخ بين العدم وبدء الحكاية، هو كأنك ترى ظلال الرواية قبل أن تُفتح الستارة. مثل مشهد الحلم الذي تراه قبل أن تستيقظ على الواقع، أو كأن الكلمة تتحرك تحت السطح، لكن لم تخرج بعد.
وبما أن الأوفرتور يسبق الحدث، فهو امتحانك الأول كمُتلقي: هل تستطيع أن تنصت؟ أن تدخل في الحالة؟ أن تفهم ما لا يُقال بعد؟
هو دعوة لدخول الهيكل، قبل أن يبدأ الطقس.

وهكذا، لا تكون الOverture مجرد عزف افتتاحي، بل أشبه برسالة مشفّرة من المؤلف إلى المستمع: “لن أخبرك الحكاية بعد، لكنني سأُغمرك في رائحتها.”
فكر في موزارت وهو يفتح ستار أوبرا “زواج فيغارو”، لا ليمنحك تلميحا عن الأحداث، بل ليقذفك في دوامة من الحيوية، ويتركك تركض خلف المزاج وحده، وكأن الطاقة وحدها كافية لتكون نبوءة موسيقية، أو كأنما يقول لك:
“لا داعي لأن تفهم. فقط ابدأ بالركض وراء الإيقاع!”

أو خذ مندلسون في مقدمته “كهف فينغال”، حيث لا حكاية تُروى، بل موجات موسيقية تُلقي بك على صخور الخيال، كأنك واقف على حافة كهف أزلي، تسمع صدى ما قبل الرواية. علماً بأن مقدمة مندلسون ليست لأوبرا، بل “Overture” بمفهومها الحر.

وفي العصر الحديث، يأتي برنشتاين بمقدمة “كانديد”، فيُشعل المسرح قبل أن يُضاء، مُعلناً أن بعض القصص لا تبدأ بالكلمة، بل تبدأ بلهيب السمع.
تُعلّمنا هذه المقدمات أن الانتظار ليس فراغا، بل هو اللحظة التي يُربّي فيها المؤلف مزاجك، كمن يسكب كأس النبيذ قبل أن يصل الطبق الرئيسي، ويبتسم ساخراً لأنه يعرف أنك بالفعل قد سكرت قبل أن تأكل.

النهاية: الكلمة كخاتمة وجود
الغريب في الأمر، أننا في معظم الأحيان نبدأ بالصمت، ولا نعود إليه. فمعظم الأغاني لا تنتهي بموسيقى، بل بكلمة. كأن الكلمة حين تولد، تُصبح النهاية نفسها، ولا يعود هناك ضرورة للمزيد.
النهاية الموسيقية، حين تحدث، تكون قصيرة عادة، كأنها زفرة الروح الأخيرة بعد أن قالت كل ما عندها. كأن الأصل أن يُترك المستمع مع آخر جملة، فالكلمة الأخيرة هي الخاتمة، وهي الحكم، وهي الطابع الذي يُختم به الوجود. وما إن تنتهي الأغنية، حتى لا يُعاد تشكيل العالم، بل يُعاد ترديد ما قيل.
فنحن لا نصمت بعد الأغنية، بل نُردّد،، نغنّي ما قيل،، نحفظه،، نمنحه الخلود.
ومع ذلك، فهذه أيضاً ليست القاعدة!
فالخاتمة في الموسيقى لا تأتي على نحو واحد!
في الغرب، يسمون الخاتمة أحيانا ب Coda، الكلمة الإيطالية التي تعني حرفيا: “الذيل”.
لكن هذا الذيل ليس زائدة، بل خاتم النوتة،
ذلك المقطع القصير الذي لا يُضاف لإكمال المعنى،
بل لإعطاء الجملة الأخيرة نَفَسا أبديا.
في الموسيقى الكلاسيكية، تُكتب الكودا أحيانا بعد انتهاء كل شيء،
كأنها تقول: “نعم، قلنا كل شيء، لكننا نريدك أن تظل تفكر.”

هي ليست نهاية، بل انعكاس خافت للأثر،
كأن اللحن، بعد أن قال كل ما لديه، ينظر خلفه للمرة الأخيرة…
ويترك ظله على الجدار.
وفي الأغاني العربية، وإن لم يُستخدم المصطلح،
فإن بعض اللزمات الختامية تؤدي نفس الوظيفة،
ذلك الجزء الذي يأتي بعد الزفرة الأخيرة،
في لحظة يبدو فيها أن الأغنية انتهت،
لكن الفرقة تُصرّ أن تُهدهدك قليلا قبل أن تُطفأ الأنوار.
في “رسالة من تحت الماء”، تسمع الكودا لا كخاتمة، بل كطيف صوتي
يمرّ فوقك مثل موجة أخيرة تُربت على كتفك، وتنسحب.
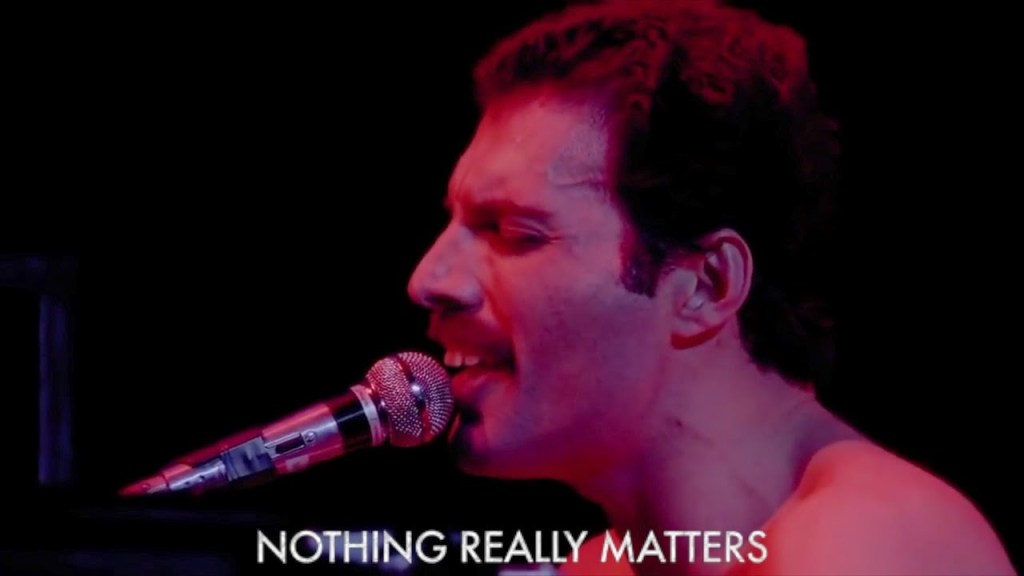
لكن ليس كل النهايات تُسدل الستار بخشوع…
أحيانًا، تأتي الخاتمة كصفعة خفيفة على قفا الوجود الإنساني، تذكير ساخر بأن الحياة لا تأبه لطقوسك الجادة.
هنا، تتسلل مقطوعة بريئة مثل Frolic للإيطالي لوتيشانو ميشيليني، ذاك اللحن الذي وُلد ليكون خلفية خفيفة، فإذا به يتحوّل في ثقافة البوب إلى أيقونة ساخرة، تُلصق في ذيل كل مشهد عبثي ينتهي بمفارقة تتركك بين الضحك والبكاء.
كأنها تقول: “ها قد انتهى العرض، ليس بعظمة، بل بسخرية القدر.”
وهكذا، تُثبت لنا الموسيقى أن الخاتمة ليست دائمًا زفرة الروح، بل قد تكون ضحكة صفراء، ضحكة من النوع الذي يُطلقه الكون حين يرى خطايانا تتكرر بنفس الإيقاع، فيبتسم ابتسامة Frolic ويتركنا نواجه عبثنا.
لأن بعض الأغاني تنتهي، لا لكي تكتمل، بل لكي تذكّرك أن الكمال وهم، وأن أفضل ما يمكن أن تفعله بعد كل تلك العظمة، هو أن تضحك، رغماً عنك.
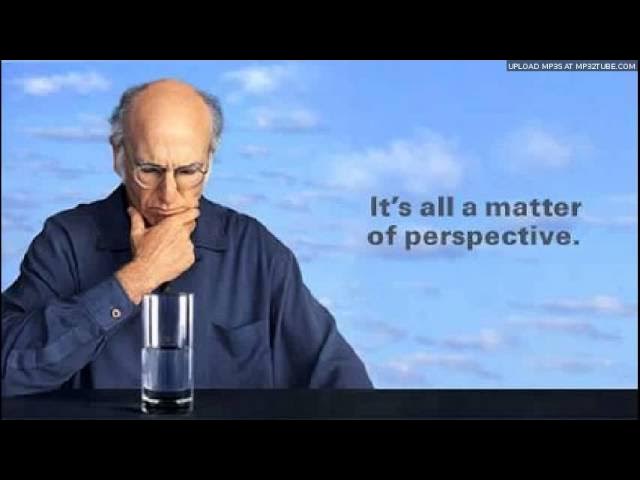
اللازمة… عندما تتوقف الكلمات احتراما لما هو أعمق
في أغاني عبد الحليم الطويلة، هناك لحظات لا يجرؤ فيها الصوت على الكلام، لأن الموسيقى وحدها تعرف أن بعض المعاني لا تُقال.
تأمل اللازمة التي تسبق “في حياتك يا ولدي امرأة” في قارئة الفنجان، ستجد نفسك لا تسمع مجرد نغمات، بل كأنك تمشي في ممر ضيق بين نبوءتين، فالموسيقى هنا ليست تمهيدا، بل إنذار صامت، وكأن الفرقة كلها تتواطأ مع القدر لتُخبرك: “انتبه… ما سيُقال الآن سيُغيّرك.”

أما حين تصل إلى اللازمة التي تسبق “ستفتش عنها يا ولدي”، فأنت لم تعد المستمع ذاته، لقد تم استدراجك إلى عمق الحكاية، والموسيقى هنا تُشبه تلك اللحظة في الأفلام حين تُغلق الأبواب خلف البطل، ولا يبقى أمامه سوى مواجهة الحقيقة وحده.
ثم خذ قفزة إلى “موعود”،، في ذلك المقطع الموسيقي قبل “شوف بقينا فين يا قلبي”. ذلك المقطع الذي رسمه بليغ حمدي بروحه ليس مجرد لازمة، بل يشبه مقصلة لحنية وجدانية، وكأن الموسيقى تتلذذ بتعليقك بين الندم والخوف، تُصعّدك مع آلة ثم تُسلمك لآلة أخرى كأنك جثة شعورية تنتظر الحكم النهائي. لاحظ كيف تنتقل الموسيقى فجأة إلى إيقاع مختلف قبل أن يبدأ حليم بغناء هذا المقطع. إنه درس في كيف تُفاجئ المستمع بمرآته، تُجبره أن يركض خلف اللحن، حتى إذا ما وصل للكلمة، وجد نفسه يلهث معها.

وفي “رسالة من تحت الماء”، وقبل “الموج الأزرق في عينيك”، تتوقف الأنفاس. فالموسيقى هناك ليست سوى غرق متعمّد، تتركك اللازمة تبتلع ماء الشوق قطرة قطرة، قبل أن يُنطق بك إلى سطح الكلمات.
في يد العباقرة، لم يكن الإيقاع مجرد خلفية ولا المقام مجرد هوية لحنية ثابتة، بل كانت أدوات مرنة كالزمن نفسه. التقنيات التي استخدمها الموجي وبليغ وعبد الوهاب والقصبجي وغيرهم لم تكن محكومة بقوانين جامدة، بل كانت أشبه بخيوط يتحكمون بها في أعصاب المستمع دون أن يدري.
تغيير الإيقاع، تلك اللحظة التي تتسارع فيها الدقات أو تتباطأ، لم يكن يأتي كقرار أكاديمي، بل كأنه التسارع المفاجئ لنبض قلب عاشق عندما يسمع اسم محبوبه.

أما تغيير المقام، فكان يُستخدم كأداة للانزلاق الشعوري، في لحظة هادئة، تجد الكمان يسرقك من مقام الراست إلى الحجاز أو الصبا، وكأنك لم تعد في نفس الغرفة الشعورية التي بدأت منها. هذه التقنية تُشبه ما يفعله المخرج السينمائي حين يُبدّل لون الإضاءة فجأة، ليُخبرك أن المزاج تغيّر، حتى لو لم ينطق أحد بشيء.
والأدهى، هو كيف كانوا يُتقنون التدفق السردي للموسيقى، ما يُسمى عند الموسيقيين بالFlow حيث لا تشعر متى تغيّر كل شيء، لكن تجد نفسك في نهاية المقطع وقد سافرت عبر مقامات وإيقاعات دون أن تدرك أين ومتى بدأت الرحلة.
التكرار: بعث الأغنية كخلق جديد
كم مرة استمعت إلى أغنية ولم تُعجبك في البداية، ثم مع التكرار أصبحت من المفضلات لديك؟ هذا ليس مصادفة، بل يُعرف في علم النفس بـ”تأثير التعرض البسيط” (Mere Exposure Effect)، حيث يؤدي التكرار إلى تعزيز التفضيل تجاه المثيرات المألوفة.

حين نعيد سماع أغنية نحبها، لا نفعل ذلك لمجرد المتعة. نحن نعيد طقسا مقدّسا، نكرّر لحظة الخلق الأولى. تماما كما تتكرّر مواسم الأرض، والولادة، وأدوار القمر، تعود الأغنية لا كما هي، بل كما صِرنا نحن.
في حفلات أم كلثوم، لم يكن التكرار مجرد تقنية فنية، بل كان طقسا جماعيا يُعزز من حالة “الطرب” بين الفنانة والجمهور. كان الجمهور يطلب منها تكرار مقاطع معينة، وكانت تلبي هذه الطلبات بإبداع، مضيفة تغييرات طفيفة في كل مرة، مما يُبقي الأداء حيا ومتجددا. هذا التفاعل الحي بين الفنانة والجمهور يُظهر كيف يمكن للتكرار أن يكون أداة للتواصل العميق والتجربة المشتركة .

في المقابل، في الشانسون الفرنسي، كما في أداءات إديث بياف وداليدا، كان التكرار أقل حضورا في الحفلات الحية. كانت الأغاني تُؤدى بشكل ثابت، مع التركيز على التعبير العاطفي الداخلي والكلمات الشعرية. هذا يعكس الفلسفة الغربية التي تميل إلى تقديم العمل الفني ككل متكامل، دون تدخل مباشر من الجمهور أثناء الأداء.

ولعل التكرار في الثقافة العربية مرتبط بفكرة الدوران الصوفي، حيث الإعادة تقودك للغوص أعمق مع كل دورة. أما في الثقافة الغربية، فهي أقرب لفكرة الخط المستقيم، حيث تُقال الكلمة مرة واحدة، كما لو أنها سهم نحو الهدف.
في الإعادة، لا تتكرر المقدمة فقط، بل يُعاد تشغيل الكون الصغير الذي بُني بين المقدمة والنهاية. نعود إلى الصمت الأول، لكننا لسنا كما كنّا.
المرّة الثانية ليست تكرارا، بل تجل آخر للكلمة نفسها، كأن كل استماع هو تفسير جديد لنص واحد، وكل إصغاء يحمل بصمتنا العاطفية الجديدة.
وبهذا تصبح الأغنية مرآة لرحلتنا الداخلية، ومختبرا للزمن داخلنا، وكل مرة نعيدها، نحن نقول للوجود: “لا أكتفي بما قيل، أريد أن أُولد من جديد.”
غوردييف، الروحاني الأرمني الغامض، أدرك سرّ هذا التكرار الروحي. فهو لم يرَ في الموسيقى مجرد نغمات تُطرب الأذن، بل بوابة تُفتح مع كل دورة، لا تعيدك إلى النقطة ذاتها، بل ترفعك لدوّامة أعلى.
في فيلم Meetings with Remarkable Men، المبنى على سيرة غوردييف وكتاباته، تتجلى تلك الرقصة الصوفية المصاحبة للموسيقى المتكررة كأنها دوران الكواكب حول وعي الإنسان، حيث كل تكرار ليس دورانا في الفراغ، بل محاولة للاقتراب أكثر من مركز الحقيقة، حتى لو لم تصلها أبداً.
كأن غوردييف علّم أتباعه أن التكرار المُتقن يُعيد تشكيلك، وأن كل “إعادة تشغيل” للّحن هي اختبار للروح: هل ستسمع ما وراء النغمة هذه المرة؟ أم أنك ستبقى عالقًا في ظاهر الصوت؟
في النهاية، سواء كنت تطلب من أم كلثوم أن تُعيد المقطع للمرة العاشرة، أو تجد نفسك غارقا في دوران موسيقى غوردييف، فأنت في حضرة طقس كوني. طقس يُذكّرك أن التكرار ليس مضيعة للوقت، بل هو الفرصة الوحيدة لكي تُولد من جديد، كلما ظننت أن الأغنية انتهت.

حين تغنّي الأغنية، يغنّي الكون معك
الموسيقى ليست فنا للترفيه.
إنها سيرة الخلق المصغّرة، تبدأ بصمت، تمر بوجع، تُثمر بكلمة، وتنتهي بزفرة.
والمستمع الحقيقي ليس من يُطرب، بل من يتحوّل: من يدخل الأغنية ككائن ما، ويخرج منها وقد تَغيّر، وقد أصبح كائنا جديداً، وقد صار شريكا في خلق الأغنية حين تذوقها، أو على الأقل شاهدا على سرّها !
وفي كل مقدمة موسيقية نسمعها، وفي كل موال يئن قبل الكلام، وفي كل أوفرتور ينذرنا بما سيأتي، وفي كل تكرار نعيده كأننا نستنطق الغيب، هناك كون صغير يُعاد تشكيله داخلنا.
فاحذر كيف تسمع!
لأن بعض الأصوات لا تمرّ على أذنك فقط… بل تكتب اسمك على لوح من لحن، وتجعل منك شاهدا على لحظة لم توجد من قبل، ولن تعود أبدا، إلا إن أعدت الأغنية.
وهناك، حيث يعيدك الطرب إلى أول دهشتك، تسمع في الخلفية صوت عبد الحليم لا يُغني، بل يهمس لك بسؤال لا يُجاب: “لو حكينا يا حبيبي… نبتدي منين الحكاية؟”
كأن كل إعادة للأغنية ليست حنينا لما فات، بل شجاعة أن تعترف: أن كل لحن تُعيده، هو محاولة جديدة لفهم الحكاية التي لم تبدأ أصلا، ولن تنتهي.
فالطرب الحقيقي لا يُغني لك قصة، بل يُعيدك إلى السؤال الأزلي:
“من أين نبدأ، حين لا نريد للنهاية أن تأتي أبداً؟”

محمد عبد القادر الفار

أضف تعليق